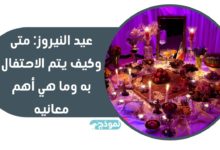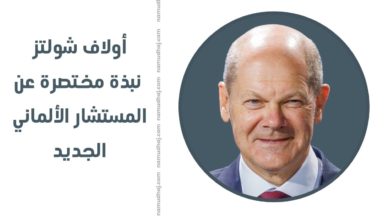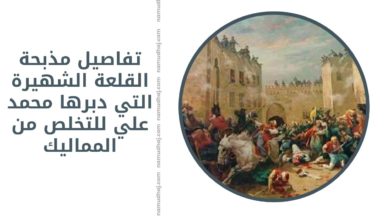فوائد الثنائية اللغوية وتحديات تعليمها
في محتوى هذا المقال
لا تُقاسُ الثراءاتُ الإنسانيةُ بعددِ اللغاتِ التي تُحلِّقُ في فضاء الوجدان فحسب، بل بذلك الجسرِ الخفيِّ الذي يربطُ بين الماضي والحاضر، بين الجذورِ والأغصان. تُدرك الدكتورة “أدريانا وايسليدر”، عالمةُ النفس التنموي وخبيرةُ اللغة من أصلٍ كوستاريكي، هذه الحقيقةَ بعمقٍ فلسفيٍّ وعلميٍّ معًا. ففي مختبرها بجامعة نورث وسترن قرب شيكاغو، حيث تُنصت إلى همساتِ الأطفال بلغاتٍ متعددة، تكتشفُ أن الثنائيةَ اللغويةَ ليست مجردَ مهارةٍ ذهنية، بل هي رحلةٌ وجوديةٌ تُعيدُ صياغةَ علاقةِ الإنسان بذاته وبالعالم.
الفصل الأول: لغتان.. عالمان.. كيف يُعيد الطفل اختراع الإدراك؟
إذا كان “طه حسين” قد رأى في اللغةِ عينَ العقلِ ومرآةَ الثقافة، فإن العلمَ الحديثَ يُثبتُ أن تعلمَ لغتين في الطفولةِ أشبهُ ببناءِ قصرٍ ذهنيٍّ بغرفٍ متعددة، لكلٍّ منها نوافذُ تطلُّ على مشهدٍ مختلف. تشرح وايسليدر أن المسارَ التطوريَّ للطفلِ الثنائيِ اللغةِ يسيرُ في نفسِ دروبِ الطفلِ أحاديِ اللغة: الكلمةُ الأولى عندَ العامِ الأول، ودمجُ الكلماتِ بعدَ ستةِ أشهر، ثم الإتقانُ التدريجيُّ. لكنَّ الفارقَ الجوهريَّ يكمنُ في ذلك الجهدِ الخفيِّ الذي يبذله العقلُ الصغيرُ لتمييزِ أنظمةٍ لغويةٍ متوازية.
الأصواتُ.. رقصةُ التمايز الخفي
تتحدثُ وايسليدر عن تحديٍّ دقيقٍ يواجهُ الثنائيينَ اللغويين: “ففي الإنجليزية، قد تُغيِّرُ نطقَ حرفٍ واحدٍ معنى الكلمةِ تمامًا (مثل bile مقابل vile)، بينما في الإسبانيةِ لا فرقَ بين صوتي الـb والـv”. هنا، يتحولُ الطفلُ إلى عالمٍ صغيرٍ يُجري تجاربَ مستمرةً لفرزِ الأصواتِ ذاتِ الدلالةِ عن تلكَ التي تذوبُ في سياقٍ لغويٍّ مختلف. هذه العمليةُ التي تبدو بسيطةً تُظهرُ براعةَ الدماغِ البشريِّ في تشكيلِ خرائطَ سمعيةٍ معقدةٍ منذُ أشهرِ الحياةِ الأولى.
المفرداتُ.. ثراءٌ يتناسقُ مع نسقِ الكون
لكلِّ لغةٍ إيقاعُها الذي يُناغمُ بين اللفظِ والمعنى. تلفت وايسليدر إلى أن الطفلَ الثنائيَّ الذي يتعرضُ للإنجليزيةِ والإسبانيةِ بنسبٍ متساويةٍ تكونُ مفرداتُه في كلِّ لغةٍ نصفَ ما لدى الأحاديِّ، لكنَّ الجمعَ بين اللغتينِ يُظهرُ أن معدلَ التطورِ اللغويَّ الكليَّ مُطابقٌ للأحاديّ. هذا التوازنُ الرياضيُّ الجميلُ يُذكِّرنا بكلماتِ العقادِ عن “اللغةِ كائنٌ حيٌّ ينمو بالاستخدام”، فكلما اتسعتْ مساحاتُ التعبيرِ، ازدهرتْ قدراتُ التفكير.
الفصل الثاني: التحدياتُ الخفية.. عندما تصطدمُ اللغاتُ بجدرانِ المجتمع
رغمَ كلِّ الإمكاناتِ التي تُظهرها الدراسات، تواجهُ العائلاتُ المهاجرةُ في الولاياتِ المتحدةِ معضلةً ثقافيةً عميقة: فبينما ترغبُ الأسرُ في الحفاظِ على اللغةِ الأمِّ كجسرٍ نحوَ التراث، تُجبرُهم المنظومةُ التعليميةُ والمجتمعُ الأوسعُ على تبني الإنجليزيةِ كلغةٍ وحيدةٍ للنجاح. هنا، تتحولُ الثنائيةُ اللغويةُ من نعمةٍ إلى محنةٍ حينما تُختزلُ الهويةُ في اختباراتٍ معياريةٍ لا ترى سوى نصفِ الحقيقة.
المدارسُ.. حيثُ تصمتُ اللغاتُ الأم
تشيرُ وايسليدر إلى أن تقييمَ الأطفالِ المهاجرينَ بالإنجليزيةِ فقط يُشبهُ حكمًا على سمفونيةٍ بآلةٍ واحدة. ففي كيبيكَ الكندية، حيثُ تُدعمُ الثنائيةُ الفرنسيةُ الإنجليزيةُ مؤسسيًا، يُظهرُ الطلابُ مستوى أكاديميًّا مكافئًا لأقرانِهم الأحاديِّين. أما في الولاياتِ المتحدة، فالاختباراتُ الأحاديةُ تُنتجُ صورةً مشوهةً لقدراتِ الطفلِ، مما يُغذي حلقةً مفرغةً من الإحباطِ الأكاديمي.
اللغةُ الأمُّ.. بين حنينِ الآباءِ ورفضِ الأبناء
تصفُ وايسليدر ظاهرةً مؤلمة: فمعَ تعمقِ اندماجِ الأجيالِ اللاحقةِ في المجتمعِ الأمريكي، يفقدُ 65% من أبناءِ الجيلِ الثالثِ القدرةَ على التواصلِ بالإسبانية. هذا الانزياحُ اللغويُّ ليس مجردَ تغييرٍ في وسيلةِ التعبير، بل هو انفصالٌ تدريجيٌّ عن ذاكرةِ الأجدادِ وحكاياتِهم. وكما قالَ محمود درويش: “اللغةُ هي ذاكرةُ الشعبِ الأخيرةُ إذا انهارتْ كلُّ الذواكر”.
الفصل الثالث: نحوَ استراتيجياتٍ إبداعية.. كيف نصنعُ جيلًا ثنائيَّ اللغةِ بلا خوف؟
إذا كانت الثنائيةُ اللغويةُ تُشبهُ زراعةَ بستانٍ باثنينِ من الأنهارِ، فإن المفتاحَ يكمنُ في ريِ الجذورِ دونَ إغراقِها. تقدمُ وايسليدر رؤىً عمليةً مستمدةً من أبحاثِها وتجربتِها الشخصيةِ كأمٍّ تُربي ابنتَها بلغتين:
اللعبُ.. أكاديميةُ الطفولةِ الذهبية
ترى وايسليدر أن اللعبَ التفاعليَّ باللغةِ الأمِّ (كالقراءةِ المشتركةِ أو سردِ الحكايات) يُنشئُ روابطَ عاطفيةً عميقةً بينَ الطفلِ واللغة. وقد أظهرتْ دراستُها أن الكتبَ ثنائيةَ اللغةِ تدفعُ الآباءَ اللاتينيينَ لاستخدامِ الإسبانيةِ بنسبةٍ أعلى، مما يُحولُ اللغةَ من أداةٍ وظيفيةٍ إلى فضاءٍ للإبداعِ والحنان.
المجتمعُ.. ذلك الحليفُ الضروريُّ
لا تكفي الأسرةُ وحدَها. فكما يحتاجُ النبتُ إلى تربةٍ خصبة، تحتاجُ اللغةُ الأمُّ إلى مجتمعٍ يُحيطُ بها. تقترحُ وايسليدر تعزيزَ البرامجِ الثقافيةِ التي تدمجُ اللغةَ معَ الفنونِ والتقاليد، كالورشِ الموسيقيةِ أو الاحتفالاتِ الشعبية. هذه الفسحاتُ ليست ترفًا، بل هي “مختبراتُ حياة” تُعيدُ للغةِ بهاءَها الاجتماعي.
خاتمة: الثنائيةُ اللغويةُ.. رسالةٌ إلى المستقبل
في ختامِ حديثِها، تلمحُ وايسليدر إلى بعدٍ فلسفيٍّ عميق: فالثنائيةُ اللغويةُ ليست مجردَ أداةٍ للتواصل، بل هي تمرينٌ يوميٌّ على قبولِ التنوعِ واحتضانِ التعقيد. إن الطفلَ الذي يعيشُ بلغتينِ يتعلمُ – دونَ وعيٍ – أن الحقيقةَ قد تُروى بطرقٍ متعددة، وأن العالمَ أكبرُ من منظورٍ واحد.
وكما كتبَ طه حسين في “الأيام”: “اللغةُ ليست ألفاظًا تُحفظ، بل أرواحٌ تُنقل”. ربما تكونُ مهمةُ هذا الجيلِ هي بناءُ جسورٍ لغويةٍ تحملُ إلى المستقبلِ ليس الكلماتِ فحسب، بل ذلك الإرثَ الإنسانيَّ الذي يصنعُ من التنوعِ مصدرًا للجمالِ والقوة.
المصادر والمراجع العلمية
حرصًا على دقة المعلومات وعمق التحليل، استند هذا المقال إلى مجموعةٍ من الدراسات العلمية والمصادر الموثوقة، نذكر منها:
- دراسة وايسليدر ورو (2020) المنشورة في الدورية السنوية لعلم النفس التنموي (Annual Review of Developmental Psychology)، والتي حللت تأثير العوامل البيئية على اكتساب اللغة لدى الأطفال ثنائيي اللغة.
- مسح مركز بيو للأبحاث (2023) حول فقدان اللغة الإسبانية عبر الأجيال بين اللاتينيين في الولايات المتحدة.
- بحث منشور في Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences (2023)، حول استراتيجيات دعم الثنائية اللغوية في السياسات التعليمية.
- تجارب مختبر لغة الطفل (Child Language Lab) بجامعة نورث وسترن، تحت إشراف الدكتورة أدريانا وايسليدر، والتي تُجري دراساتٍ حول معالجة اللغة لدى الرضع باستخدام تتبع العين.
- مقابلة خاصة مع الدكتورة وايسليدر أجرتها مجلة Knowable Magazine، والتي سلطت الضوء على تحديات العائلات المهاجرة في الحفاظ على اللغات التراثية.