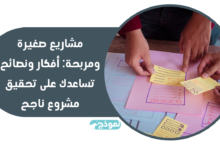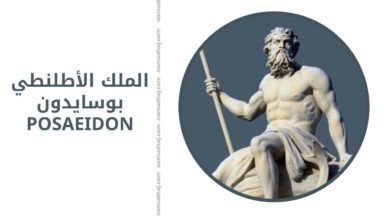اللغة العربية في عصر العولمة: بين سندان الهوية ومطرقة التحديات
العربية.. لغةٌ تبحث عن مكانها تحت شمس الرقمنة
في محتوى هذا المقال
- 1 الفصل الأول: التعليم الثنائي في العالم العربي.. بين الواقع والطموح
- 2 الفصل الثاني: الفصحى والعامية.. معضلة الهُوية اللغوية
- 3 الفصل الثالث: التكنولوجيا.. هل تنقذُ العربية من “انقراض” الأجيال؟
- 4 الفصل الرابع: السياساتُ الحكومية.. بين التغريبِ وعُقدةِ الهوية
- 5 الفصل الخامس: العرب في المهجر.. محاولاتٌ لإنقاذ “اللغة الأم”
- 6 الخاتمة: العربية.. ليست مجرد حروف، بل ذاكرةُ أمة
في زقاقٍ ضيقٍ بمدينة فاس المغربية، يجلسُ “يوسف” ذو الأعوام العشرة يُحاكي جدَّه في نطقِ كلماتٍ عربيةٍ فصحى بينما يَكتُبُ واجبَهُ المدرسيَّ بالفرنسية. هُنا، حيثُ تتصارعُ اللغاتُ على جدرانِ المدارسِ وشفاهِ الأطفال، تُطرحُ أسئلةٌ وجودية: كيف تُحافظُ العربيةُ على حضورِها في عصرٍ تُهيمنُ عليه الإنجليزيةُ والفرنسية؟ وهل يُمكنُ للتعليمِ الثنائي أن يكونَ جسرًا بين الأصالةِ والحداثة؟
الفصل الأول: التعليم الثنائي في العالم العربي.. بين الواقع والطموح
في قلبِ القاهرة، تقفُ مدرسة “الألسن الدولية” شاهدةً على نموذجٍ فريد: فصولٌ تُدرَّسُ فيها العلومُ بالعربيةِ والرياضياتُ بالإنجليزية، مع حصصٍ أسبوعيةٍ عن تراثِ ابن الهيثمِ والخوارزمي. لكنّ هذا النموذجَ يظلُّ استثناءً في عالمٍ عربيٍّ تُهيمنُ عليه مدارسُ اللغاتِ الأجنبية، حيثُ تُقدَّمُ العربيةُ كلغةٍ ثانويةٍ تُراجعُ قبلَ الامتحاناتِ فحسب.
حوار مع د. ليلى مراد (خبيرة تربوية بجامعة الدول العربية):
“التعليمُ الثنائي ليس ترفًا، بل ضرورةٌ لصنعِ جيلٍ يعرفُ أن الحضارةَ العربيةَ كانتْ تُترجمُ العلومَ قبل أوروبا بقرون. المشكلةُ أن بعضَ الأنظمةِ التعليميةِ تعاملتْ مع العربيةِ كلغةٍ دينيةٍ أو تاريخية، لا كلغةِ علومٍ وحياة”.
الأرقامُ الصادمة:
- بحسبِ تقريرِ اليونسكو (2023)، 60% من الشبابِ العربِ تحتَ 25 عامًا يُفضلونَ مشاهدةَ المحتوى الرقمي بالإنجليزية أو الفرنسية.
- في المغرب وتونس، تُقدمُ 70% من المدارسِ الخاصةِ مناهجَ كاملةً بالفرنسية، بينما تُختزلُ العربيةُ إلى 4 ساعاتٍ أسبوعيًا.
الفصل الثاني: الفصحى والعامية.. معضلة الهُوية اللغوية
في مقهى بيروتي، يتناقشُ أدباءٌ حولَ روايةٍ كُتبتْ باللهجةِ اللبنانية، بينما يعترضُ آخرون: “هذا يُهددُ وحدةَ العربية!” هذه الإشكاليةُ التاريخيةُ (الازدواجيةُ اللغوية) تُشكّلُ تحديًا فريدًا: كيف نُعلِّمُ جيلًا يجيدُ الفصحى للقراءةِ والكتابة، دونَ أن ينفصلَ عن عاميتِه التي تُعبِّرُ عن وجدانِه اليومي؟
تجربة “مدرسة الضاد” في الإمارات:
مبادرةٌ تعليميةٌ تدمجُ بين الفصحى والعاميةِ في الحواراتِ المسرحيةِ والأنشطةِ الإبداعية. يقولُ مديرُها أحمد السيد: “لا نُريدُ طفلًا يشعرُ أن الفصحى لغةُ النصوصِ الميتة، بل لغةُ حوارٍ مع التراثِ والمعاصرة”. النتيجة؟ زيادةُ نسبةِ إقبالِ الطلابِ على الشعرِ العربي بنسبة 35%.
الفصل الثالث: التكنولوجيا.. هل تنقذُ العربية من “انقراض” الأجيال؟
بينما يُنشئُ الطفلُ المصري “عمر” قناةَ يوتيوبٍ لشرحِ البرمجةِ بالعاميةِ الممزوجةِ بالإنجليزية، تُطلقُ شركةٌ ناشئةٌ في الأردنِ تطبيقَ “عربيتي” الذي يحوِّلُ تعلمَ الفصحى إلى ألعابٍ تفاعليةٍ مع شخصيةِ “منصور” الرقمي الذي يسافرُ عبرَ الزمنِ لاستكشافِ حضاراتِ العرب.
إحصاءاتٌ مُشرقة:
- تطبيق “القلم العربي” (لبناء مهارات الكتابة) حملهُ مليونُ مستخدمٍ عربي خلال 2023.
- 45% من مستخدمي “تيك توك” العربِ يُنتجونَ محتوى بالعاميةِ والفصحى معًا، وفقًا لدراسةِ جامعةِ الملك سعود.
الفصل الرابع: السياساتُ الحكومية.. بين التغريبِ وعُقدةِ الهوية
في الوقتِ الذي تُنفقُ فيه قطرُ 20% من ميزانيتِها التعليميةِ على تعزيزِ العربيةِ عبرَ مؤتمراتِ الترجمةِ ومشاريعِ الذكاءِ الاصطناعي، تُلغي مدارسُ خاصةٌ في الجزائرِ تدريسَ التاريخِ والجغرافيا بالعربيةِ لصالحِ الفرنسية. هذه المفارقةُ تعكسُ صراعًا أعمق: هل العربيةُ عبءٌ على التنميةِ أم ركيزةٌ لها؟
نجاحاتٌ مُلهمة:
- تونس: إدراجُ مادة “التراثُ اللغوي” في المناهجِ الابتدائية، مع قصصٍ مصورةٍ عن الحضارةِ القرطاجية.
- السعودية: منصةُ “مدرستي” توفّرُ 5000 فيديو تعليميٍّ بالعربيةِ الفصحى، بمشاركةِ 2 مليون طالب.
الفصل الخامس: العرب في المهجر.. محاولاتٌ لإنقاذ “اللغة الأم”
في ضواحي باريس، تجتمعُ السيدةُ “أمينة” (من أصلٍ مغربي) مع أطفالِها حولَ “خيمةِ الحروف”، وهي فكرةٌ مبتكرةٌ لتعليمِ العربيةِ عبرَ حكاياتِ الجداتِ والأغاني الشعبية. تقولُ أمينة: “أريدُ أن أعيدَ لهم صوتَ أرضِ آبائهم، حتى لو عاشوا على أرضٍ أخرى”.
تحدياتُ الجيل الثالث:
- 70% من أبناءِ الجيلِ الثالثِ للمهاجرين العربِ في أوروبا لا يُجيدونَ العربيةَ إلا بشكلٍ محدود، وفقًا لدراسةٍ ألمانيةٍ (2022).
- مبادراتٌ مثل “أسبوع العربية” في كندا تجمعُ 10 آلاف طفلٍ سنويًا عبرَ مسابقاتِ الخطِّ والإنشاد.
الخاتمة: العربية.. ليست مجرد حروف، بل ذاكرةُ أمة
كما كتبَ طه حسين: “اللغةُ ليست أداةً للتواصلِ فحسب، بل هي مرآةُ الروحِ الجماعية”. قد تكونُ العربيةُ اليومَ في مفترقِ طرق، لكنَّ تاريخَها الطويلَ مع الإبداعِ والترجمةِ يُثبتُ أنها لغةٌ قادرةٌ على التجدُّد.
التعليمُ الثنائي، والتكنولوجيا، والمبادراتُ المجتمعيةُ ليست سوى أدواتٍ لصنعِ حوارٍ جديدٍ بين الماضي والمستقبل. فالعربيةُ ليست ملكَ الأجدادِ وحدَهم، بل هي بوصلةُ الأحفادِ نحوَ هويةٍ لا تُنسى.
المصادر والمراجع:
- تقارير اليونسكو (2023) حول وضع اللغة العربية عالميًا.
- دراسة جامعة الملك سعود عن تأثير “تيك توك” على اللغة العربية.
- مقابلات مع مؤسسي تطبيق “عربيتي” ومدرسة “الضاد”.
- بيانات منصة “مدرستي” السعودية الرسمية.